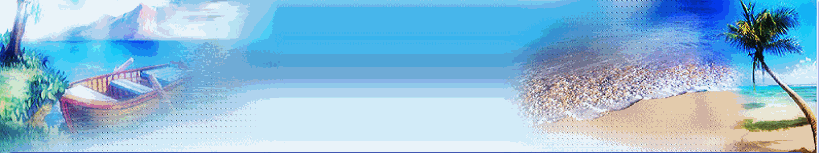حقيقة عالم الطفولة
إن علم النفس النمائي يعالج الفروق والتباينات الفردية في المنظورين الفردي والاجتماعي الثقافي في كل مرحلة من مراحل النمو, ويقدم نماذج حية من خلفيات ثقافية اجتماعية في مختلف الأزمان والأماكن, ويعرض الإضطرابات النفسية في مراحل نمو الطفل والمراهق إلى جانب النمو السوي, وهذا ينسجم مع الاتجاه الحديث في النظر إلى العلاقة التفاعلية بين السلوك السوي والسلوك الشاذ من حيث تأثيرهما
لنعامل الأطفال على أنهم أطفال:
"من بديهيات القول أن عالم الطفل متكامل وقائم بذاته، وإن كان يتضمن البذور التي تنقل الطفل إلى عالم الكبار، إلا أن هذه البديهية -والتي هي حقيقة علمية لا يدانيها الشك- هي مجرد مقولة لم تأخذ حقها من الممارسة على أرض الواقع, فالأطفال مازالوا يعاملون بأسلوب الوِصاية التي تأخذ في مفرداتها التربوية شكل الهيمنة، علماً أن هذه الطريقة التربوية لم تعد تصلح.
فالعالم الذي تحول إلى قرية صغيرة حوَّل معه كل شيء بما في ذلك طرق ووسائل تربية الأطفال، ولم يعد يحق لأحد أن يتجاهل التحولات التي عصفت بكل الفعاليات الحياتية للإنسان، حتى حق القول أن عالمنا قد أصبح من نواحٍ كثيرة عالماً جديداً ليس فيه عذرٌ للجهل أو اللامبالاة، ومواكبتنا لهذا العالم لا تكون بالإقبال على كتب الأطفال شراء؛ ودفعهم إلى القراءة أو متابعتهم دراسياً؛ أو تأمين وسائل اللعب والترفيه لهم، كل هذا على درجة من الأهمية، ولكن ثمة ما هو قبل ذلك وبعده، ألا وهو العلاقة التي تربطنا بهم وحدود هذه العلاقة ومفرداتها، فعلاقتنا بأطفالنا هي التي تحدد مستوى التعامل القائم بيننا وبينهم، فأطفالنا هم بالدرجة الأولى نتاج علاقاتنا بهم وعلاقاتنا بعضنا ببعض أيضاً، فالعلاقة بين الأبوين تشكل بيئة الطفل الاجتماعية الخاصة، ومجمل العلاقات الاجتماعية المحيطة به تشكل البيئة العامة، ولكل من البيئتين تأثيرها في حياة الطفل؛ مع اختلاف مستوى ذلك التأثير، فتأثير علاقة الأبوين بعضهما ببعض؛ غير تأثير علاقتهما بالأخرين عليه، وبذلك يتساوى -إلى حد ما- الأطفال والراشدون، بيد أن تأثُّر الراشد يُخضِع للمحاكمة العقلية أسبابَ ودوافعَ كلِّ علاقة من العلاقات سابقة الذكر، أما الطفل فإنه يأخذها بمجملها؛ حتى وإن توفرت له معلومات عن خلفياتها وأسبابها ودوافعها.
وفي العودة لنوع العلاقة التي تربطنا بالأطفال مباشرة علينا أن لا نعكس أولوياتنا على حياتهم، بمعنى أن نكيِّف مطالبنا مع حاجاتهم وقدراتهم، ويجب أن تحمل هذه المطالبَ لغةٌ تتناسب مع قاموسهم اللغوي الخاص، مع الأخذ بعين الاعتبار أننا نتوجه إلى شخص وليس فرد، أي إنسان له مقوماته الشخصية المختلفة عنَّا، وليس نموذجاً مصغراً أو أقل وعياً؛ إنه نموذج مختلف عنَّا نمواً ووعياً، ونحن حين نكيف مطالبنا مع حاجات الأطفال وقدراتهم؛ نمنح أنفسنا أكثر من سبيل للتواصل معهم والوصول إليهم، وهذا هو المهم، إذ أننا في حقيقة الأمر نسعى إلى نتائج إيجابية، سواء كان منهجنا يعتمد على نزع السوء من نفوس الأطفال أو غرس الخير في نفوسهم، وفي الحالتين نحن بحاجة إلى منهج جديد في التعامل معهم غير المنهج الذي كان -ومايزال- سائداً في أغلب المجتمعات العربية.
إذاً علينا أن ننتقل من السيطرة إلى التوجيه في علاقتنا مع الأطفال فتشكيل سلوك الطفل يوازي نموه الجسدي في الأهمية، وكما أن حياته العضوية تحتاج إلى غذاءٍ؛ كذلك حياته النفسية تحتاج إلى غذاءٍ أيضاً.
ولعل أصعب مهمة تتجلى في صياغة السؤال بطريقة يمكن معها الإجابة الواضحة.
فعلم نفس الطفل من العلوم الجديدة نسبياً في حياتنا ويجب ألا يدفعنا بعدنا عن هذا العلم إلى أن نقف مكتوفي الأيدي ونقول هذا ما نعرفه، يجب أن نحاول.. فالقضية بقدر ما هي عامة هي خاصة أيضاً, وهذا لا يكون بالالتصاق بالأطفال وتجذير الخوف في نفوسهم, فلقد بينت الدراسات النفسية أن الأطفال الذين ينتمون إلى عائلات ذات روابط أسرية قوية ويحظون برعاية فائقة واهتمام زائد عادة ما يصابون بما يسمى "قلق الإنفصال" وخاصة في المرحلة العمرية التي تمتد من السنة الأولى حتى الصف الرابع من المرحلة الإبتدائية.
ومظاهر هذا القلق تختلف عن مظاهر قلق الإنفصال عن الأم الذي يتعرض له جميع الأطفال في المراحل العمرية الأولى من حياتهم, ونلاحظ أعراض قلق الإنفصال أو الخوف من الإنفصال عند الأطفال الذين ينتمون إلى أسرٍ قوية الروابط أثناء إبتعادهم عن البيت حيث يبدو على الطفل التوتر الشديد وعدم قابلية أي شيء سواء اللعب أم الطعام أم المشاركة في الحديث إلى غير ذلك, إضافة لأعراض عضوية كالمغص والاستفراغ إضافة للأحلام والكوابيس عند النوم, لذلك تراه "أي الطفل" يرفض النوم بمفرده, وأكثر ما يُلاحظ ذلك على أطفال هذه الشريحة الاجتماعية يلاحظ عند دخولهم المدرسة, باعتبار الانتظام في الدوام المدرسي يقتضي غياب الأطفال ساعات طوال عن البيت, وفي هذه الحالة على المدرسة والأهل تفهم طبيعة هذا الخوف, وأن الأعراض المصاحبة له هي أعراض حقيقية وليست من قبيل الحيلة أو التمارض, وذلك يقتضي العلاج التدريجي مع وجود التعزيزات الضامنة للطفل, كأن يرافق أحد الوالدين أو الأخوة أو الأخوات الطفل إلى المدرسة ويلبث معه هناك لفترة وجيزة من الزمن مع محاولة إيجاد أصدقاء للطفل من طلاب نفس الصف, إضافة لتفهم المدرسة والزيارات المتكررة التي يقوم بها أفراد عائلة هذا الطفل إلى المدرسة بشكل دوري إلى أن يأخذ الطفل موقعه الاجتماعي بين أقرانه, ويحس معهم بالأمان, وهنا تتجلى الرسالة الإنسانية والتربوية التي على المعلم أن يبلغها, فالطفل في حقيقة الأمر لا يمكن أن يأخذ المسار المرسوم له في الحياة ما لم يشعر بالإنتماء إلى ذلك المسار.